إذا كنت بتفكر إنك فاهم شو اللي بصير حوالينا… استعد للصدمة، لأن الحقيقة غير كل شي سمعته!

في عصر تتسارع فيه وتيرة المعلومات، ويغمرنا فيض هائل من البيانات التي تصلنا عبر وسائل الإعلام المختلفة، بات من السهل جدًا أن نشعر أننا نعي العالم ونفهم تفاصيله الدقيقة. التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث التي تحوي ملايين المقالات والتقارير، كلها تساهم في خلق إحساس زائف بالتمكن والمعرفة. لكن، هل هذا الإدراك فعلاً يعكس حقيقة الواقع؟ أم أننا نقف أمام ظاهرة معقدة تنضح بالتحيزات، والفلترة، والإخفاء المقصود؟
إن دراسة الأنظمة الإعلامية ومناهج البحث في علوم الاتصال تؤكد أن ما يُعرَض لنا يوميًا لا يعبر بالضرورة عن الحقيقة الموضوعية (Objective Reality)، بل هو نسخة مُنتَقاة ومُشكّلة وفق أجندات سياسية، اقتصادية، أو ثقافية. ويُطلق على هذا المفهوم في العلوم الاجتماعية “بناء الواقع الاجتماعي” (Social Construction of Reality)، والذي يشير إلى الطريقة التي يُعاد فيها إنتاج الواقع وتفسيره عبر وسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة، الأمر الذي قد يُبعدنا عن الفهم الحقيقي للأحداث.
كما أن التلاعب بالمعلومات، وتوظيف “نظرية التهيئة” (Agenda-Setting Theory) التي تبين كيف تتحكم وسائل الإعلام في ترتيب الأولويات والقضايا التي يجب أن تشغل اهتمام الجمهور، يجعل من المشهد الذي نراه أمامنا مشهدًا مشوّهًا لا يعكس سوى جزءًا من الحقيقة الكاملة. بل أحيانًا يُقصى عن الأنظار ما قد يُغير مجرى الرأي العام.
إضافة إلى ذلك، يعاني متلقي المعلومات من “تحيّز التأكيد” (Confirmation Bias)، وهو الميل إلى قبول المعلومات التي تؤكد المعتقدات السابقة ورفض ما يخالفها، مما يخلق فقاعات معلوماتية (Echo Chambers) تُكرّس لهذا الفهم الجزئي والسطحي.
في ضوء ذلك، يظهر لنا أن عملية فهم الواقع ليست مهمة بسيطة، بل هي عملية معقدة تتطلب التعمق، والتحقق من مصادر متعددة، وإعادة بناء السياقات، واستخدام أدوات البحث العلمي التي تعتمد على التوثيق، والتحليل النقدي، والمقارنة بين المصادر المختلفة.
على الرغم من ذلك، تميل الكثير من المجتمعات إلى الاكتفاء بالمعلومات السطحية التي تقدمها وسائل الإعلام السائدة، أو حتى تداول “الأخبار الزائفة” (Fake News) والشائعات التي تنتشر بسرعة فائقة في الشبكات الاجتماعية، الأمر الذي يؤثر على القدرة التحليلية للجمهور ويحد من وعيه تجاه ما يجري بالفعل.
هذه الظاهرة ليست مجرد حالة عابرة، بل تُعتبر أزمة حقيقية في مجالات الاتصال والإعلام، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تعزيز “الوعي الإعلامي” (Media Literacy) لدى الأفراد، وهو مفهوم يشمل القدرة على الوصول إلى المعلومات، وتحليلها، وتقويمها بشكل نقدي، بهدف الوصول إلى صورة أوضح وأكثر دقة للواقع.
كما أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التصفية الموجهة (Algorithmic Filtering) على منصات التواصل الاجتماعي يزيد من تعقيد المشهد، إذ تعمل هذه الخوارزميات على تخصيص المحتوى بما يتوافق مع اهتمامات وتفضيلات المستخدم، مما يزيد من احتمالية تعزيز الفقاعات المعلوماتية ويحد من التعرض للآراء والأفكار المختلفة.
وبهذا، نصل إلى السؤال المحوري: هل نحن فعلاً نفهم ما يجري حولنا؟
الجواب هو: لا، ليس بالكامل.
ما نراه ونعرفه غالبًا هو صورة ناقصة ومشوهة من الواقع. الحقيقة وراء الأحداث أكبر، وأكثر تعقيدًا، وأحيانًا أكثر صدمة مما تتصور. ولا يدرك هذا إلا من ينهض من الغفلة، ويتسلح بالمعرفة النقدية، ويبدأ رحلة البحث والتمحيص المستمر.
فإذا أردت أن تخرج من دوامة التلاعب بالمعلومات والتصورات الخاطئة، عليك أن تصبح باحثًا واعيًا، لا تكتفي بالسطحي، بل تحفر أعمق، تقرأ أكثر، وتتحقق من كل معلومة، وتواجه أفكارك المسبقة بتحدٍ دائم. عندها فقط ستقترب من فهم الحقيقة التي تحيط بنا، والتي قد تغير نظرتك للعالم بشكل لا يمكن تصوره.
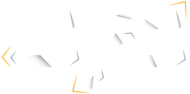
تعليقات